سرديات عودة
مقتطفات من رواية " قواعد العشق الأربعون" للروائية التركية إيليف شفق (الإثنين 2 أيلول 2013)
(رواية عن جلال الدين الرومي)
ترجمة خالد الجبيلي
عندما كنت طفلاً، رأيت الله،
رأيت ملائكة؛
رأيت أسرار العالمين العلوي والسفلي. ظننت أن جميع الرجال رأوا ما رأيته. لكنّي سرعان ما أدركت أنهم لم يروا...
شمس التبريزي
استهلال
تمسك قطعة من الحجر بين أصابعك، ترفعها ثم تلقيها في مياه دافقة. قد لا يكون من السهل رؤية ذلك. إذ ستتشكل مويجة على سطح الماء الذي سقط فيه الحجر، ويتناثر رذاذ الماء، لكن ماء النهر المتدفق يكبحها. هذا كلّ ما في الأمر.
ارم حجراً في بحيرة، ولن يكون تأثيرها مرئياً فقط، بل سيدوم فترة أطول بكثير. إذ سيعكّر الحجر صفو المياه الراكدة، وسيشكّل دائرة في البقعة التي سقط فيها، وبلمح البصر، ستتسع تلك الدائرة، وتشكّل دائرة إثر دائرة. وسرعان ما تتوسع المويجات التي أحدثها صوت سقوط الحجر حتى تظهر على سطح الماء الذي يشبه المرآة، ولن تتوقف هذه الدائرة وتتلاشى، إلا عندما تبلغ الدوائر الشاطئ.
إذا ألقيت حجراً في النهر، فإن النهر سيعتبره مجرد حركة أخرى من الفوضى في مجراه الصاخب المضطرب. لا شيء غير عادي. لا شيء لا يمكن السيطرة عليه.
أما إذا سقط الحجر في بحيرة، فلن تعود البحيرة ذاتها مرة أخرى.
طوال أربعين عاماً، كانت حياة إيلا روبنشتاين مثل مياه راكدة - سلسلة من العادات والاحتياجات والتفضيلات المتوقّعة. ومع أنها كانت حياة رتيبة وعادية من نواحٍ عديدة، فإن إيلا لم تكن تجدها متعبة ومملة. وخلال العشرين السنة الأخيرة، كانت كلّ رغبة تعتريها، وكلّ شخص تصادقه، وكلّ قرار تتخذه، يحدّق من خلال منظار زواجها. وكان زوجها، دافيد، طبيب أسنان ناجحاً، يعمل ساعات طويلة، فجمع الكثير من المال. كانت تعرف أن علاقتهما لم تكن عميقة، لكنها كانت تقول لنفسها ليس من الضروري أن يحتل الارتباط العاطفي أولوية في قائمة حياة المتزوجين، ولاسيما بالنسبة لزوجين مضت فترة طويلة على زواجهما. ففي الزواج أشياء أهم بكثير من العاطفة والعشق، كالتفاهم والمودّة والرحمة، وأن أكثر الأشياء الإلهية التي قد يقدم عليها أي زوج، هو الصفح. أما الحبّ فهو ثانوي مقارنة بكلّ هذه الأشياء. إلا إذا كان المرء يعيش في ثنايا الروايات أو الأفلام الرومانسية، حيث يصوَّر الأبطال دائماً أشخاصاً أضخم من الحياة، ولا يعدو حبّهم أن يكون سوى أسطورة.
وكان أطفال إيلا يتصدرون قائمة أولوياتها. فلديهما فتاة جميلة في الجامعة، جانيت، ومراهقان توأمان، أورلي وآفي؛ ولديهما أيضاً سبيريت، الكلب الذهبي اللون البالغ من العمر اثنتي عشرة سنة، الذي يرافق إيلا في جولاتها الصباحية، والذي كان أشدّ رفاقها سعادة عندما كان جرواً، لكنه كبر الآن، وازداد وزنه، ولم يعد يسمع، وكاد أن يصبح أعمى. لا بد أن حياة سبيريت قد شارفت على نهايتها، لكن إيلا تريد أن تعتقد أنه سيعيش إلى الأبد. فلم تصادف في حياتها موت أيّ شيء، سواء أكان عادة، أم مرحلة، أم زواجاً، حتى لو برزت أمامها النهاية، جلية وحتمية.
تعيش أسرة روبنشتاين في نورثامبتون، بولاية ماسوشوستس، في منزل كبير مشيّد على الطراز الفيكتوري. ومع أن البيت بحاجة إلى بعض الترميم، فهو لا يزال بيتاً رائعاً، وهو يتألف من خمس غرف نوم، وثلاثة حمّامات، تكسوه أرضية خشبية صلبة لامعة، وفيه كراج يتسع لثلاث سيارات، وله أبواب زجاجية واسعة، ويوجد جاكوزي في الحديقة. ولدى الأسرة تأمين على الحياة، وتأمين على السيارات، وبرامج للتقاعد، وخطط توفير في الجامعة، ولديها حساب مصرفي مشترك. وبالإضافة إلى المنزل الذي يقيمون فيه، لدى الأسرة شقّتان فاخرتان أخريان: شقّة في بوسطن، وأخرى في رود آيلاند. لقد بذلت هي وديفيد جهداً كبيراً للحصول على كل ذلك. بيت واسع مليء بالأطفال، أثاث رائع؛ ومع أن رائحة الفطائر المخبوزة التي تملأ البيت قد تبدو للبعض شيئاً مكرراً، فهي تشكل لهما صورة لحياة مثالية. لقد أقاما زواجهما على هذه الرؤية المشتركة فحققا الكثير من أحلامهما، إن لم يكن كلّها.
في عيد فالانتاين الأخير، أهداها زوجها قلادة ماسية في شكل قلب، مرفقة ببطاقة كُتب فيها:
إلى عزيزتي إيلا،
المرأة الهادئة الطباع، ذات القلب الطيب، التي تتحلى بصبر قديسة، أشكرك لأنك تقبلينني كما أنا. أشكرك لأنك زوجتي.
حبيبك
دايفيد
لم تعترف إيلا لديفيد بذلك من قبل، لكنها عندما قرأت بطاقته، أحست أنها تقرأ نعياً. قالت لنفسها: هذا ما سيكتبونه عني عندما أموت، وإن كانوا مخلصين، يمكنهم إضافة هذه العبارة أيضاً:
مع أن إيلا كانت قد ركزت جلّ حياتها على زوجها وأطفالها، فهي تفتقر إلى أساليب الحياة التي قد تساعدها على التغلب على مشاق الحياة وحدها. فهي ليست من النوع الذي يحب المجازفة، إذ إن تغيير نوع القهوة التي تحتسيها كلّ يوم، يعتبر جهداً كبيراً بالنسبة لها.
ولهذه الأسباب جميعها، لم يستطع أحد، بمن فيهم إيلا نفسها، تفسير حقيقة ما يجري عندما تقدمت بطلب للطلاق في خريف عام 2008، بعد مضي عشرين سنة على زواجها.
***
لكن كان هناك سبب. إنه الحبّ.
لم يكونا يعيشان في المدينة نفسها، ولا حتى في القارة ذاتها. ولم تكن تفصلهما أميال كثيرة فقط، بل كانا كذلك مختلفين اختلاف الليل والنهار. وكان أسلوبا حياتهما مختلفين إلى درجة استحالة أن يتحمّل أحدهما وجود الآخر، فما بالك بأن يحبّ أحدهما الآخر. لكنّ ذلك حدث فعلاً. وقد حدث ذلك بسرعة، بسرعة كبيرة لم يتح لإيلا فيه وقت لتدرك حقيقة ما يجري، ولكي تحذر من الحبّ.
دهم الحبّ إيلا بغتة وبعنف كما لو أن أحداً ألقى حجراً من مكان ما في بركة حياتها الساكنة.
مقدمة:
كان القرن الثالث عشر، المفعم بالصراعات الدينية، والنزاعات السياسية، والصراعات اللانهائية على السلطة، فترة مضطربة في منطقة الأناضول. ففي الغرب، احتل الصليبيون القسطنطينية وعاثوا فيها فساداً وهم في طريقهم لاحتلال القدس، فقسمت الامبراطورية البيزنطية. وفي الشرق، انتشرت جيوش المغول بسرعة كبيرة بقيادة القائد العسكري العبقري جنكيزخان. وفي الوسط، كانت القبائل التركية المختلفة تتحارب فيما بينها، بينما كان البيزنطيون يحاولون استرجاع أرضهم وثروتهم وقوتهم التي فقدوها. كانت فترة من الفوضى لم يسبق لها مثيل، حيث كان المسيحيون يقاتلون المسيحيين، والمسيحيون يقاتلون المسلمين، والمسلمون يقاتلون المسلمين. فحيثما ولىّ المرء وجهه، كان هناك اقتتال وألم وخوف شديد لما يمكن أن يحدث بعد ذلك. وفي خضم هذه الفوضى، عاش عالم إسلامي جليل، يعرف باسم جلال الدين الرومي، ويُلقّب "بمولانا"، يحيط به آلاف المريدين والمعجبين من المنطقة كلها وما وراءها، وكان يُعتبر منارة للمسلمين جميعاً.
وفي سنة 1244ميلادي، التقى الرومي بشمس – الدرويش الجوّال ذو التصرفات الغريبة والآراء الهرطقية. وقد غيّر لقاؤهما هذا حياة كلّ منهما. وكان هذا اللقاء بداية لصداقة فريدة متينة شبّهها الصوفيون في القرون التالية باتحاد محيطين اثنين. وبعد لقاء الرومي بهذا الرفيق الاستثنائي، تحوّل من رجل دين عادي إلى شاعر يجيش بالعاطفة، وصوفي ملتزم، وداعية إلى الحبّ، فابتدع رقصة الدراويش، وتحرر من جميع القيود والقواعد التقليدية. وفي عصر سادته روح التعصب والنزاعات الدينية، دعا إلى روحانية عالمية شاملة، مشرعاً أبوابه أمام جميع البشر من مختلف المشارب والخلفيات. وبدلاً من أن يدعو إلى الجهاد الخارجي، الذي يعرّف "بالحرب على الكفّار"، الذي دعا إليه الكثيرون في ذلك الزمان، تماماً كما يجري في يومنا هذا – دعا الرومي إلى الجهاد الداخلي، وتمثّل هدفه في جهاد "الأنا"، وجهاد "النفس" وقهرها في نهاية الأمر.
لكن أفكاره لم تلق ترحيباً من جميع الناس، ولم يفتحوا جميعهم قلوبهم للمحبّة. وأصبحت الرابطة الروحية القوية بين شمس التبريزي والرومي نهباً للشائعات والافتراءات والتهجمات. وأسيء فهمهما، وأصبحا موضع حسد، وذمّ، وحطّ الناس من قدرهما، وخانهما أقرب المقربين إليهما. وبعد مضي ثلاث سنوات على لقائهما، انفصلا على نحو مأساوي.
لكن القصّة لم تنته هناك.
في واقع الحال، لم تكن هناك نهاية. فبعد مضي زهاء ثمانمائة سنة، لا تزال روح شمس وروح الرومي تنبضان بالحياة حتى يومنا هذا، تدوران في وسطنا في مكان ما...
القاتل
الإسكندرية، تشرين الثاني (نوفمبر) 1252
تحت مياه داكنة في أحد الآبار، يرقد ميتاً الآن. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت عيناه تتبعاني حيثما ولّيت، براقتان، مهيبتان، مثل نجمتين داكنتين، معلقتين على نحو ينذر بالشؤم في أعالي السماء. فقد أتيت إلى الإسكندرية بأمل أن أستطيع، إن أنا سافرت إلى مكان بعيد، أن أهرب من هذه الذاكرة الثاقبة وأن أوقف ذلك العويل الذي يتردّد صداه في رأسي، تلك الصيحة الأخيرة التي انطلقت منه قبل أن يصفى دمه، وتجحظ عيناه، وتغلق حنجرته في لهاث غير منته، وداع رجل مطعون بالسكين. عواء ذئب وقع في مصيدة.
عندما تقتل أحداً، فإن شيئاً منه ينتقل إليك - تنهيدة، أو رائحة، أو إيماءة. وأنا أدعوها "لعنة الضحيّة". تلتصق بجسمك وتتغلغل في جلدك، وتسري مباشرة إلى قلبك، وتظل تنغل في داخلك. ولا يملك أحد ممن يراني في الشارع وسيلة معرفة ذلك، لكني أحمل معي آثار جميع الرجال الذين قتلتهم. أعلقهم حول رقبتي مثل قلائد خفية، أحسّ بوجودهم فوق لحمي، بإحكام وبثقل. ومع أنني لا أشعر بالراحة، فقد اعتدت العيش مع هذا العبء، وقبلته كجزء من عملي. ومنذ أن قتل قابيل هابيل، ففي كلّ قاتل، يتنفّس الرجل الذي قتله، هذا ما أعرفه، وهو أمر لا يزعجني. لم يعد يزعجني. لكن، لماذا اعترتني تلك الرجفة القوية بعد تلك الحادثة السريعة؟
كان كلّ شيء مختلفاً هذه المرة، منذ البداية. فهاكم الطريقة التي وجدت العمل فيها مثلاً، أم هل عليّ أن أقول الطريقة التي وجدني فيها العمل؟ ففي بداية ربيع سنة 1248، كنت أعمل لدى صاحبة مبغى في قونية، خنثى معروفة بشدّة غضبها، وكنت أساعدها في مراقبة العاهرات، وبث الرعب في نفوس الزبائن الذين لا يحسنون التصرف.
أذكر ذلك اليوم بجلاء. فقد كنت أطارد عاهرة هربت من المبغى بحثاً عن الله. كانت شابّة جميلة، كادت تحطم قلبي، لأنني إذا ما لحقت بها، كنت أنوي أن أشوّه وجهها بحيث لا يعود رجل يرغب في النظر إليه. كنت على وشك الإمساك بهذه المرأة الغبية عندما وجدت رسالة غامضة ملقاة عند عتبة باب بيتي. ولمّا كنت أمياً لا أجيد القراءة، فقد أخذتها إلى المدرسة، وأعطيتها لأحد الطلاب ليقرأها لي ودفعت له مبلغاً لقاء ذلك.
ثم تبين لي أنها رسالة من مجهول وقّع عليها "عدد من المؤمنين المخلصين".
تقول الرسالة: "لقد عرفنا من مصدر موثوق من أنت ومن أين أتيت وأين تعمل. عضو سابق في فرقة الحشاشين! ونعرف كذلك أن الفرقة لم تعد قوية كما كانت بعد أن مات حسن الصباح وسجن زعمائك. ونعرف أنك جئت إلى قونية هرباً من القصاص، وأنك تعيش متنكّراً منذ ذلك الحين".
وذكرت الرسالة أنهم في حاجة ماسة إلى خدماتي، وأنهم سيدفعون لي مبلغاً جيداً من المال. وقالوا إن عليّ، إن كنت مهتمّاً بالأمر، أن أتوجه إلى حانة مشهورة في ذلك المساء بعد حلول الظلام. وعندما أصل إلى تلك الحانة، أجلس إلى أقرب طاولة إلى النافذة، مولياً ظهري للباب، مطرق الرأس، وأن أثبّت عينيّ في الأرض. ثمّ سيأتي إليّ الشخص أو الأشخاص الذين سيستخدمونني، ويقدمون لي كلّ المعلومات التي أحتاج إلى معرفتها. ويجب عليّ ألاّ أرفع رأسي وأنظر إلى وجوههم عندما يصلون أو عندما يغادرون، أو خلال حديثنا.
كانت رسالة غريبة. لكني كنت معتاداً على التعامل مع نزوات الزبائن. فعلى مرّ السنين، استخدمني أشخاص من جميع الأنواع، وكان معظمهم يرغب في الاحتفاظ بسرية أسمائهم. وعلّمتني التجربة، أنه في أحيان كثيرة، كلما بذل الزبون جهداً لإخفاء هويته، كان أقرب إلى ضحيّته، لكن لا شأن لي بذلك. إذ تنحصر مهمّتي في تنفيذ عملية قتل. وألاّ أسأل عن الأسباب الكامنة وراء مهمتي. ومنذ أن غادرت "ألموت" منذ عدة سنوات، كانت تلك هي الحياة التي اخترتها لنفسي.
وفي جميع الأحوال، نادراً ما كنت أطرح أسئلة. فلماذا أسأل؟ فمعظم الذين أعرفهم لدى كل واحد منهم على الأقل شخص يريد التخلّص منه. وعندما لا يفعلون شيئاً إزاء ذلك، فهذا لا يعني أنهم محصّنون من الرغبة في قتلهم. وفي الواقع، توجد في داخل كلّ شخص رغبة دفينة في قتل أحدهم ذات يوم. والناس لا يدركون ذلك، إلا بعد أن تحدث لهم. فهم يظنون أنهم عاجزون عن القتل. لكن المسألة مسألة ضمير فحسب. ففي بعض الأحيان، تكفي مجرد إيماءة لتأجيج سورة غضبهم. سوء فهم متعمّد، شجار على شيء تافه، أو أن يتواجد المرء في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ، إذ يمكن أن تظهر نزعة تدميرية لدى الأشخاص الذين يكونون أشخاصاً طيبين ومحترمين في الأحوال العادية. إذ يمكن لأي شخص أن يقتل أي شخص. لكن ليس بإمكان أي شخص أن يقتل شخصاً غريباً عامداً متعمداً، وهنا أدخل إلى الصورة.
كنت أنفذ الأعمال القذرة لصالح الآخرين. حتى الله أدرك الحاجة إلى شخص مثلي في خطته المقدّسة عندما عيّن عزرائيل، ملاك الموت، لإنهاء حياة الناس. وهكذا يخاف الناس الملاك ويلعنونه ويمقتونه، بينما تظل يدا الله نظيفتين، ويظل اسمه نقياً. وفي ذلك جور على هذا الملاك. لكن للمرة الثانية أقول إن العالم كله يسوده الظلم، أليس كذلك؟
عندما هبط الليل، توجهت إلى الحانة. وشاءت الصدف أن يجلس رجل في وجهه ندبة، إلى الطاولة بالقرب من النافذة، ويغطّ في النوم. خطر لي أن أوقظه وأطلب منه الانتقال إلى طاولة أخرى، لكنك لا تعرف ماذا يمكن أن تكون عليه ردة فعل السكارى، لذلك كان عليّ أن أتوخى الحذر، وألاّ ألفت الانتباه إليّ. لذلك، جلست إلى الطاولة الفارغة التالية، قبالة النافذة.
وبعد قليل وصل رجلان، وجلسا إلى جانبيّ لكي لا أرى وجهيهما. لم أكن بحاجة لأن أنظر إليهما، لأدرك أنهما شابان، وأنهما غير مستعدين لاتخاذ الخطوة التي كانا على وشك اتخاذها.
"لقد جاءتنا توصية عالية بك"، قال أحدهم، لم تكن نبرته حذرة بقدر ما كانت متردّدة، "قيل لنا إنك الأفضل".
بدت طريقة قوله مضحكة، لكنني كتمت ابتسامتي. لاحظت أنهما كانا خائفين، وهو أمر جيد. فعندما يكونان خائفين، لن يجرآ على ارتكاب أي خطأ معي.
لذلك قلت: "نعم، أنا الأفضل، لذلك يطلقون عليّ اسم "رأس ابن آوى". ولم أخذل زبائني قط، مهما بلغت صعوبة تلك المهمّة".
"جيد"، قال متنهّداً، "لأن هذه المهمة قد لا تكون سهلة".
وهنا تحدّث الشاب الآخر وقال: "انظر، لقد كسب هذا الرجل لنفسه أعداء كثيرين. فمنذ أن جاء إلى هذه البلدة، لم يجلب شيئاً سوى المشاكل. حذّرناه عدة مرات، لكنه لم يستمع إلى قولنا له، وأصبح مشاكساً ومثيراً للمشاكل.لم يدع أمامنا أي خيار آخر".
كانت الأمور تسير على هذا المنوال باستمرار. ففي كلّ مرة، يحاول الزبائن تفسير ما سيقدمون عليه، قبل أن نتوصل إلى اتفاق، وكأن موافقتي قد تقلّل من خطورة ما سيقدمون على عمله.
فسألتهما، "فهمت قصدكما. قولا لي، من هو هذا الشخص؟" ترددا في ذكر الاسم، وقدما أوصافاً غامضة.
"إنه رجل زنديق لا يمت بصلة إلى الإسلام. إنه عنيد، جامح، يكتنفه الرجس والكفر. إنه درويش مارق".
ما إن سمعت الكلمة الأخيرة، حتى سرى في ذراعي إحساس مخيف. وأخذ عقلي يفكّر بسرعة. لقد قتلت جميع أنواع البشر، صغاراً وكباراً، رجالاً ونساء، لكنني لم أقتل قط درويشاً، رجلاً مؤمناً. فأنا أؤمن بالخرافات ولم أكن أرغب في أن أجلب عليّ غضب الله، لأنني على الرغم من كلّ شيء، أؤمن به.
"أظن أني سأرفض طلبكما. لا أظن أني أريد أن أقتل رجل دين. ابحثا عن شخص آخر".
وبنهاية قولي هذا، استويت واقفاً متهيئاً للمغادرة. لكن أحد الرجلين أمسكني من يدي، وقال متوسلاً: "انتظر أرجوك: سيتناسب المبلغ مع الجهد الذي ستبذله. ومهما بلغ الأجر الذي تتقاضاه، فإننا على استعداد لمضاعفة المبلغ".
"ماذا عن ثلاثة أضعاف؟" سألتهما، مقتنعاً بأنهما لن يزيدا المبلغ كثيراً.
لكن لدهشتي، وبعد تردد، وقف كلاهما. عدت وجلست في مقعدي، متوتراً. فبهذا المبلغ يمكنني أن أسدد مهر عروس وأن أتزوّج أخيراً، ولن يساورني قلق بشأن تدبير أمور معيشتي. درويشاً أم غير دوريش، فأي شخص جدير بأن يقتل لقاء هذا المبلغ.
كيف كان لي أن أعرف أنني ارتكبت في تلك اللحظة أكبر خطأ في حياتي، وأنني سأمضي بقية حياتي نادماً على ما اقترفته يداي؟ كيف يمكنني معرفة أن قتل الدرويش سيكون أمراً في غاية الصعوبة، وأنه حتى بعد مرور فترة طويلة على وفاته، ستتعقبني نظرته الحادة كالسكين في كل مكان؟
مضت الآن أربع سنوات منذ أن طعنته في ذلك الفناء، وألقيت بجسده في بئر، ورحت أنتظر سماع صوت سقوطه في الماء، وهو ما لم أسمعه أبداً. لم يصدر أي صوت. فبدل أن يسقط في الماء، يبدو أنه صعد إلى السماء. وما زلت لا يغمض لي جفن من دون أن تنتابني كوابيس، وعندما أنظر إلى الماء، أيّ مصدر ماء، لبضع ثوان، يتملك جسدي كله رعب بارد، فأتقيأ.
شمس
حانة في ظاهر سمرقند، آذار (مارس) 1242
ارتعش أمام عينيّ ضوء الشموع المصنوعة من شمع النحل والمنتصبة فوق المنضدة الخشبية المتشققة. وغمرتني هذا المساء رؤية شديدة الإشراق.
رأيت بيتاً كبيراً ذا فناء تكسوه الورود المتبرعمة الصفر، وفي وسط الفناء بئر بقبع فيه أبرد ماء في الدنيا. كانت ليلة صافية في أواخر الخريف، وقد تكبد البدر صفحة السماء الصافية. تناهت إليّ من بعيد أصوات نعيق وعواء حيوانات ليلية. وبعد قليل، خرج من البيت رجل في منتصف العمر، لطيف الوجه، له كتفان عريضتان، وعينان عميقتان بندقيتا اللون، يبحث عني. كانت قسمات وجهه متوترة، وعيناه تشيان بحزن شديد.
"شمس، شمس، أين أنت؟" صاح وهو يتلفت يميناً ويساراً.
هبّت ريح عاصفة، وتوارى القمر وراء غيمة،كأنه لا يريد أن يشهد ما سيحدث. وتوقّف البوم عن النعيب، ولم يعد الخفاش يصفق بجناحيه، وحتى النار في الموقد داخل البيت، لم تعد تصطفق.
وأطبق سكون تام على العالم.
ببطء، اقترب الرجل من البئر، وانحنى، وراح ينظر إلى الأسفل. وهمس، "شمس، يا أعزّ أعزائي، هل أنتَ هنا؟"
فتحت فمي لأجيب، لكن لم ينبعث من بين شفتيّ أي صوت.
انحنى الرجل أكثر، وحدّق في البئر ثانية. في البداية لم ير شيئاً سوى سواد الماء. لكنه بعد ذلك، وفي أعماق البئر، رأى يدي تطوف بلا هدف فوق الماء المترقرق، مثل طوافة زعزعتها الريح الشديدة. ثم تبيّن عينين – حدقتان سوداوان تلمعان، تحدقان في البدر الذي بدأ ينسلّ الآن من وراء الغيوم الداكنة الكثيفة. تسمّرت عيناي على القمر كأنهما تنتظران تفسيراً من السماء عن سبب قتلي.
خرّ الرجل ساجداً، وراح يجهش في البكاء ويخبط على صدره بقبضتيه ويصرخ: "لقد قتلوه! لقد قتلوا شمساً".
عندئذ انبثق ظلّ من وراء أجمة، وبحركات سريعة خفية قفز فوق جدار الحديقة، مثل قطّ بري. لكن الرجل لم ير القاتل. كان يُعتصر ألماً، ولم يكفّ عن الصراخ والعويل حتى تهشم صوته كما يتهشم الزجاج، وتناثر في أرجاء الليل في شظايا دقيقة واخزة.
"هيه، أنت! كفّ عن الصراخ كالمجنون".
"...."
"كفّ عن هذا الصراخ وإلا طردتك خارجاً".
"..."
"قلت اخرس! هل تسمعني؟ اسكت".
كان صوت الرجل الذي صدرت منه هذه الكلمات، يزداد قرباً مني على نحو مخيف. تظاهرت أنني لم أسمعه، مفضّلاً البقاء داخل رؤياي لأطول فترة من الزمن. كنت أريد أن أعرف المزيد عن موتي، كما كنت أريد أن أرى الرجل صاحب أشدّ العيون حزناً. من هو؟ ما علاقته بي، ولماذا كان يبحث عنّي باستماتة في ليلة من ليالي الخريف؟
لكن قبل أن أتمكن من اختلاس نظرة أخرى، أمسكني أحدهم من ذراعي من عالم آخر وراح يهزني بقوة حتى أحسست بأسناني تصطك في فمي. وجرتني قبضته إلى هذا العالم.
ببطء، وبتردّد، فتحت عينيّ ورأيت الرجل يقف بجانبي. كان رجلاً مربوع القامة، له لحية وَخَطَها الشيب، وله شاربان كثان، معقوفان ومفتولان عند الطرفين. أدركت أنه صاحب الحانة. وعلى الفور لاحظت أمرين اثنين فيه وهما: أنه الرجل الذي يزرع الخوف في نفوس الناس بكلامه الفظ وسلوكه العنيف؛ وأنه الآن في حالة غضب شديد.
سألته، "ماذا تريد؟ لماذا تشدّ ذراعي؟"
"ماذا أريد؟" قال صاحب الحانة هادراً، متجهماً، "أريد أن تكفّ عن الصراخ، هذا ما أريد. إنك تبث الخوف في زبائني".
"حقاً؟ هل كنت أصرخ؟" دمدمت بعد أن حررت يدي من قبضته.
"أراهن على أنك كنت تصرخ! كنت تصرخ مثل دب انغرزت في كفّه شوكة. ماذا دهاك؟ هل غفوت أثناء العشاء؟ لا بدّ أنك رأيت كابوساً أو شيئاً من هذا القبيل".
أعرف أن هذا هو التفسير المعقول الوحيد، وأنني لو قبلته، لقبل صاحب الحانة وتركني أغادر بسلام. لكني لم أرد أن أكذب".
فقلت: "لا، يا أخي، فأنا لم أنم ولم أر كابوساً. بل إنني لا أرى أحلاماً قط".
" إذن كيف تفسر صراخك هذا؟" أراد صاحب الحانة أن يعرف.
فقلت: "لقد جاءتني رؤيا. وهذا أمر مختلف".
رمقني بنظرة ملؤها الحيرة ولعق طرفي شاربيه، ثم قال: "أنتم الدراويش مجانين كالجرذان في مخزن المؤن، ولاسيما الدروايش الجوالون. فأنتم تصومون النهار كلّه، وتصلّون وتمشون تحت أشعة الشمس الحارقة. لا عجب أنك بدأت تهلوس – ثمة لوثة في عقلك".
ابتسمتُ. قد يكون محقّاً في القول إن هناك خيطاً رفيعاً بين أن تستغرق في الله وأن تفقد عقلك.
في تلك اللحظة، ظهر صبيّان خادمان، يحملان بينهما صينية ضخمة كدّست فوقها أطباق كثيرة: عنزة مشوية، سمك مجفّف مملّح، لحم ضأن متبّل، وكعك مصنوع من الحنطة، وحمص مع قطع من كرات اللحم، وشوربة عدس طهيت بإلية خروف. وأخذا يطوفان في أرجاء القاعة، يوزعان الطعام على الحاضرين، مالئين الهواء بروائح البصل والثوم والتوابل. وعندما توقّفا عند طرفيّ المائدة، أخذت زبدية من الحساء كان البخار يتصاعد منها وقليلاً من الخبز الأسمر الغامق.
"هل لديك نقود تدفع ثمنها؟" سأل صاحب الحانة، بشيء من العجرفة.
فقلت: "لا، لا نقود لديّ، لكن يمكنني أن أقدم لك شيئاً مقابل ذلك. مقابل الطعام والإقامة. إذ يمكنني أن أفسّر لك أحلامك".
فرد باحتقار، واضعاً ذراعيه على خصره، "لقد قلت للتو إنك لا ترى أحلاماً".
"صحيح. فأنا مفسّر أحلام ولكن لا أرى أحلاماً".
"يجب أن ألقي بك إلى الخارج. كما قلت، إنكم معشر الدراويش مجانين"، قال صاحب الحانة.
"ها هي نصيحة أقدمها لك. فأنا لا أعرف كم عمرك، لكنني واثق من أنك صلّيت بما يكفي لكلا العالمين. جد امرأة جميلة واستقرّ. انجب أطفالاً. فهذا سيساعدك على أن تبقي قدميك على الأرض. فما فائدة التجوال في العالم والبؤس والتعاسة منتشران في كل مكان؟ صدقني. لا شيء جديد. عندي زبائن من أقصى أصقاع العالم، وبعد أن يجرعوا بعض الكؤوس، أسمع القصص نفسها منهم جميعاً. فالبشر هم أنفسهم في كل مكان. والطعام نفسه، والماء نفسه، والحماقة القديمة نفسها".
فقلت: "إني لا أبحث عن شيء مختلف. إني أبحث عن الله. إن مسعاي هو البحث عن الله".
فردّ وقد غلظ صوته فجأة، "إذن فإنك تبحث عنه في المكان الخطأ. لقد هجر الله هذا المكان! ولا نعرف متى سيعود".
عندما سمعت هذه الكلمات، سقط قلبي فوق جدار صدري، وقلت: "عندما لا يذكر المرء الله بسوء، فإنه يسيء التكلّم عن نفسه".
ارتسمت على فم صاحب الحانة ابتسامة خبيثة؛ ورأيت في وجهه مرارة واستياء، وشيئاً آخر يشبه الألم المرتسم على وجه طفل.
ثم سألته: "ألا يقول الله "وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ"؟ فالله لا يقبع بعيداً في السموات العالية، بل يقبع في داخل كلّ منا. لذلك فهو لا يتخلّى عنا، فكيف له أن يتخلّى عن نفسه؟"
"لكنه لا يتخلى عنا"، ردد صاحب الحانة، عيناه باردتان ومتحدّيتان، "إن كان الله هنا فهو لا يحرك ساكناً، ونحن نعاني من أسوأ النهايات، فماذا يعني ذلك؟"
فقلت: "إنها القاعدة الأولى يا أخي: إن الطريقة التي نرى فيها الله ما هي إلا انعكاس للطريقة التي نرى فيها أنفسنا. فإذا لم يكن الله يجلب إلى عقولنا سوى الخوف والملامة، فهذا يعني أن قدراً كبيراً من الخوف والملامة يتدفّق في نفوسنا. أما إذا رأينا الله مفعماً بالمحبة والرحمة، فإننا نكون كذلك".
فأجاب صاحب الحانة معترضاً، لأن كلماتي فاجأته، "كيف يختلف ذلك عن القول بأن الله هو صورة من نسج خيالنا؟ لم أفهم".
لكن جلبة صاخبة انبعثت من خلف قاعة الطعام، جعلتني أتوقف عن إجابته. وعندما التفتنا نحو مصدر الصوت، رأينا رجلين فظين ثملين يهذران بصوت عال بكلام غير مفهوم. وقد أطلقا العنان للإهانات والشتائم، وأدخلا الرعب في نفوس الزبائن الآخرين، وراحا يختطفان الطعام من طاساتهم، ويشربان من أكوابهم، فإذا أبدى أحد احتجاجاً، كانا يسخران منه مثل صبيين شقيين في "كُتَّاب".
"ألا تظن أنه يجب أن يكبح أحد جماح هذين الغوغائيين؟" همس صاحب الحانة بين أسنانه المطبقة، وأضاف، "انظر ماذا سأفعل الآن".
وبلمح البصر بلغ نهاية القاعة، فشدّ أحد الزبونين الثملين من مقعده، ولطمه على وجهه. لا بد أن الرجل لم يكن يتوقّع ذلك قط، فتهاوى على الأرض مثل كيس فارغ. وسوى آهة خفيفة انبعثت من بين شفتيه، لم يندَّ عنه أي صوت.
وتبين أن الرجل الآخر أقوى من الأول، فقد قاوم بعنف، لكن صاحب الحانة سرعان ما ألقى به أرضاً، وبدأ يركل زبونه الحرون على أضلاعه، ثم داس على يده، وسحقها تحت حذائه الثقيل. وسمعنا صوت طقطقة إصبع، أو أكثر ينكسر.
فصحت، "توقّف عن ذلك. إنك ستقتله. أهذا ما تنوي عمله؟"
ولمّا كنت صوفياً، فقد أقسمت على أن أحمي حياة الناس وألاّ ألحق أذى بأحد. ففي عالم الأوهام الذي نحياه، يوجد الكثير من الناس المستعدين للتشاجر دونما سبب، وآخرون يتشاجرون لسبب ما. أما الصوفي فلا يتشاجر مع أحد حتى لو كان لديه سبب يدعوه إلى ذلك. فلا يوجد ثمة داع يجعلني ألجأ إلى العنف. لكن بإمكاني أن ألقي بنفسي مثل بطانية ناعمة بين صاحب الحانة والزبونين لأفصلهم عن بعضهم.
"ابتعد أيها الدرويش، وإلا ضربتك أنت أيضاً ضرباً مبرحاً"، صاح صاحب الحانة، مع أننا كنا نعرف أنه لن يفعل ذلك.
بعد دقيقة حمل الخادمان الزبونين اللذين كُسر إصبع أحدهما، وكُسر أنف الآخر، وتناثر الدم في كل مكان. وخيّم على قاعة الطعام صمت مفعم بالخوف. ثم رمقني صاحب الحانة، الذي كان فخوراً بالرعب الذي أشاعه، بنظرة جانبية. وعندما تكلم ثانية، بدا وكأنه يخاطب الحاضرين جميعاً، وارتفع صوته وأصبح مسعوراً، مثل طير من الجوارح يحوم بخيلاء في السماء.
"كما ترى أيها الدرويش، فالأمور لا تسير هكذا على الدوام. فلم يكن العنف من شيمي، لكنه أصبح الآن. فعندما ينسانا الله ويتركنا وحيدين هنا، يقع على عاتقنا، نحن الناس العاديين، أن نصبح أشداء أو نحقق العدل بأيدينا. لذلك عندما تكلمه في المرة القادمة، أرجو أن تخبره ذلك. وسأقول له إنه عندما يتخلى عن حملانه، فلن تنتظر هذه الحملان بوداعة وخنوع حتى تُذبح. بل ستتحول إلى ذئاب".
هززت كتفي ّوأشرت نحو الباب، وقلت: "إنك مخطئ".
"هل أخطأت في القول بأنني كنت حملاً ذات يوم وأصبحت ذئباً اليوم؟"
"لا، إنك محق. فأنا أرى أنك أصبحت ذئباً حقاً، لكنك أخطأت عندما قلت إنك تحقق العدالة".
"انتظر،لم أفرغ منك بعد"، صاح صاحب الحانة ورائي، "إنك مدين لي. مقابل الطعام والمأوى، كنت ستفسّر لي أحلامي".
"سأفعل شيئاً أفضل"، اقترحت، "سأقرأ لك كفّك".
استدرت وسرت نحوه، وأنا أحدّق في عينيه الملتهبتين. وبشكل غريزي، ومرتاب، أجفل. لكنني عندما أمسكت يده اليمنى، ورفعت راحتيَ يديه إلى الأعلى،لم يدفعني جانباً. وأمعنت النظر في خطوط راحته، فوجدتها عميقة، مشققة، تشير إلى دروب وممرات متقطعة غير مستقيمة. وشيئاً فشيئاً، بدت لي الألوان في هالته: بني بلون الصدأ، وأزرق شاحب أقرب إلى الرمادي. وأصبحت طاقته الروحية جوفاء مقعّرة، ورقّت حول الحافات، كما لو خلت منه أي قوة للدفاع عن نفسه من العالم الخارجي. وفي أعماقه، لم يعد في الرجل حياة أكثر مما في نبتة ذابلة. وللتعويض عن فقدان طاقته الروحية، ضاعف من طاقته الجسدية، التي أفرط في استخدامها.
بدأ قلبي يخفق بسرعة، لأنني بدأت أرى شيئاً. في البداية على نحو باهت، كما لو كان من وراء حجاب، ثمّ بدأ يتضح أكثر، ثمّ برز أمام عينيّ مشهد.
شابّة ذات شعر كستنائي، وقدمين حافيتين رسم عليهما وشم أسود، وحول كتفيها التف شال أحمر مطّرز.
قلت: "لقد فقدت حبيبة"، وأمسكت راحة يده اليسرى بيدي.
كان ثدياها يطفحان بالحليب، وبطنها ضخمة جداً وكأنها ستتمزّق إرباً إرباً. كانت عالقة في كوخ يحترق. وكان محاربون يدورون حول البيت، ممتطين خيولاً عليها سروج من الفضة والذهب. وكانت تفوح رائحة واخزة من احتراق القشّ واللحم البشري.
فرسان مغول، أنوفهم مفلطحة وعريضة، رقابهم غليظة وقصيرة، وقلوبهم قاسية كالصوان. جيش جنكيزخان القوي.
"لقد فقدتَ حبيبين"، قلت مصحّحاً نفسي، "فقد كانت زوجتك حاملاً بطفلك الأول".
قوّس صاحب الحانة حاجبيه، وثبّت عينيه على حذائه الجلدي الطويل، وزمّ شفتيه بشدة، وتغضّن وجهه مثل خريطة لا يمكن تبين معالمها. وفجأة بدت عليه ملامح الشيخوخة أكثر من عمره الحقيقي.
قلت: "أعرف أن هذا ليس تعزية لك، بل أظن أن هناك شيئاً يجب أن تعرفه. فلم تقتلها النار أو الدخان. بل انهار لوح خشبي من السقف وسقط على رأسها، وماتت على الفور، من دون ألم. كنت تظن دائماً أنها عانت كثيراً، لكنها في الحقيقة، لم تتألم على الإطلاق".
قطّب صاحب الحانة حاجبيه، وانحنى بتأثير ضغط لا يفهمه أحد سواه؛ وازداد صوته خشونة عندما سأل، "كيف عرفت كل ذلك؟"
تجاهلت سؤاله، وقلت: "إنك تلوم نفسك لأنك لم تقم لها جنازة لائقة. إنك لا تزال تظهر في أحلامك، تخرج زاحفة من الحفرة التي دفنت فيها، لكن عقلك يتلاعب بك. في الحقيقة، إن زوجتك وابنك بخير، وهما يتنقلان في العالم اللا نهائي، حرّان مثل نقطتي نور".
ثمّ أضفت، وأنا أدرس كلّ كلمة أقولها بعناية، "يمكنك أن تصبح حملاً ثانية، لأنك لا تزال تحتفظ بالحمل في داخلك".
عندما سمع ذلك، سحب صاحب الحانة يده من يدي، كما لو أنه لمس مقلاة ساخنة، وقال: "لا أحبّك، أيها الدرويش. سأسمح لك بالمكوث هنا الليلة، لكنك يجب أن تغادر في الصباح الباكر. لا أريد أن أرى وجهك هنا ثانية".
هكذا هي الحياة. فعندما تخبر أحدهم بالحقيقة، فإنه يكرهك. وكلما تحدّثت عن الحبّ، ازدادت كراهيته لك.
التعليق
(رواية عن جلال الدين الرومي)
ترجمة خالد الجبيلي
عندما كنت طفلاً، رأيت الله،
رأيت ملائكة؛
رأيت أسرار العالمين العلوي والسفلي. ظننت أن جميع الرجال رأوا ما رأيته. لكنّي سرعان ما أدركت أنهم لم يروا...
شمس التبريزي
استهلال
تمسك قطعة من الحجر بين أصابعك، ترفعها ثم تلقيها في مياه دافقة. قد لا يكون من السهل رؤية ذلك. إذ ستتشكل مويجة على سطح الماء الذي سقط فيه الحجر، ويتناثر رذاذ الماء، لكن ماء النهر المتدفق يكبحها. هذا كلّ ما في الأمر.
ارم حجراً في بحيرة، ولن يكون تأثيرها مرئياً فقط، بل سيدوم فترة أطول بكثير. إذ سيعكّر الحجر صفو المياه الراكدة، وسيشكّل دائرة في البقعة التي سقط فيها، وبلمح البصر، ستتسع تلك الدائرة، وتشكّل دائرة إثر دائرة. وسرعان ما تتوسع المويجات التي أحدثها صوت سقوط الحجر حتى تظهر على سطح الماء الذي يشبه المرآة، ولن تتوقف هذه الدائرة وتتلاشى، إلا عندما تبلغ الدوائر الشاطئ.
إذا ألقيت حجراً في النهر، فإن النهر سيعتبره مجرد حركة أخرى من الفوضى في مجراه الصاخب المضطرب. لا شيء غير عادي. لا شيء لا يمكن السيطرة عليه.
أما إذا سقط الحجر في بحيرة، فلن تعود البحيرة ذاتها مرة أخرى.
طوال أربعين عاماً، كانت حياة إيلا روبنشتاين مثل مياه راكدة - سلسلة من العادات والاحتياجات والتفضيلات المتوقّعة. ومع أنها كانت حياة رتيبة وعادية من نواحٍ عديدة، فإن إيلا لم تكن تجدها متعبة ومملة. وخلال العشرين السنة الأخيرة، كانت كلّ رغبة تعتريها، وكلّ شخص تصادقه، وكلّ قرار تتخذه، يحدّق من خلال منظار زواجها. وكان زوجها، دافيد، طبيب أسنان ناجحاً، يعمل ساعات طويلة، فجمع الكثير من المال. كانت تعرف أن علاقتهما لم تكن عميقة، لكنها كانت تقول لنفسها ليس من الضروري أن يحتل الارتباط العاطفي أولوية في قائمة حياة المتزوجين، ولاسيما بالنسبة لزوجين مضت فترة طويلة على زواجهما. ففي الزواج أشياء أهم بكثير من العاطفة والعشق، كالتفاهم والمودّة والرحمة، وأن أكثر الأشياء الإلهية التي قد يقدم عليها أي زوج، هو الصفح. أما الحبّ فهو ثانوي مقارنة بكلّ هذه الأشياء. إلا إذا كان المرء يعيش في ثنايا الروايات أو الأفلام الرومانسية، حيث يصوَّر الأبطال دائماً أشخاصاً أضخم من الحياة، ولا يعدو حبّهم أن يكون سوى أسطورة.
وكان أطفال إيلا يتصدرون قائمة أولوياتها. فلديهما فتاة جميلة في الجامعة، جانيت، ومراهقان توأمان، أورلي وآفي؛ ولديهما أيضاً سبيريت، الكلب الذهبي اللون البالغ من العمر اثنتي عشرة سنة، الذي يرافق إيلا في جولاتها الصباحية، والذي كان أشدّ رفاقها سعادة عندما كان جرواً، لكنه كبر الآن، وازداد وزنه، ولم يعد يسمع، وكاد أن يصبح أعمى. لا بد أن حياة سبيريت قد شارفت على نهايتها، لكن إيلا تريد أن تعتقد أنه سيعيش إلى الأبد. فلم تصادف في حياتها موت أيّ شيء، سواء أكان عادة، أم مرحلة، أم زواجاً، حتى لو برزت أمامها النهاية، جلية وحتمية.
تعيش أسرة روبنشتاين في نورثامبتون، بولاية ماسوشوستس، في منزل كبير مشيّد على الطراز الفيكتوري. ومع أن البيت بحاجة إلى بعض الترميم، فهو لا يزال بيتاً رائعاً، وهو يتألف من خمس غرف نوم، وثلاثة حمّامات، تكسوه أرضية خشبية صلبة لامعة، وفيه كراج يتسع لثلاث سيارات، وله أبواب زجاجية واسعة، ويوجد جاكوزي في الحديقة. ولدى الأسرة تأمين على الحياة، وتأمين على السيارات، وبرامج للتقاعد، وخطط توفير في الجامعة، ولديها حساب مصرفي مشترك. وبالإضافة إلى المنزل الذي يقيمون فيه، لدى الأسرة شقّتان فاخرتان أخريان: شقّة في بوسطن، وأخرى في رود آيلاند. لقد بذلت هي وديفيد جهداً كبيراً للحصول على كل ذلك. بيت واسع مليء بالأطفال، أثاث رائع؛ ومع أن رائحة الفطائر المخبوزة التي تملأ البيت قد تبدو للبعض شيئاً مكرراً، فهي تشكل لهما صورة لحياة مثالية. لقد أقاما زواجهما على هذه الرؤية المشتركة فحققا الكثير من أحلامهما، إن لم يكن كلّها.
في عيد فالانتاين الأخير، أهداها زوجها قلادة ماسية في شكل قلب، مرفقة ببطاقة كُتب فيها:
إلى عزيزتي إيلا،
المرأة الهادئة الطباع، ذات القلب الطيب، التي تتحلى بصبر قديسة، أشكرك لأنك تقبلينني كما أنا. أشكرك لأنك زوجتي.
حبيبك
دايفيد
لم تعترف إيلا لديفيد بذلك من قبل، لكنها عندما قرأت بطاقته، أحست أنها تقرأ نعياً. قالت لنفسها: هذا ما سيكتبونه عني عندما أموت، وإن كانوا مخلصين، يمكنهم إضافة هذه العبارة أيضاً:
مع أن إيلا كانت قد ركزت جلّ حياتها على زوجها وأطفالها، فهي تفتقر إلى أساليب الحياة التي قد تساعدها على التغلب على مشاق الحياة وحدها. فهي ليست من النوع الذي يحب المجازفة، إذ إن تغيير نوع القهوة التي تحتسيها كلّ يوم، يعتبر جهداً كبيراً بالنسبة لها.
ولهذه الأسباب جميعها، لم يستطع أحد، بمن فيهم إيلا نفسها، تفسير حقيقة ما يجري عندما تقدمت بطلب للطلاق في خريف عام 2008، بعد مضي عشرين سنة على زواجها.
***
لكن كان هناك سبب. إنه الحبّ.
لم يكونا يعيشان في المدينة نفسها، ولا حتى في القارة ذاتها. ولم تكن تفصلهما أميال كثيرة فقط، بل كانا كذلك مختلفين اختلاف الليل والنهار. وكان أسلوبا حياتهما مختلفين إلى درجة استحالة أن يتحمّل أحدهما وجود الآخر، فما بالك بأن يحبّ أحدهما الآخر. لكنّ ذلك حدث فعلاً. وقد حدث ذلك بسرعة، بسرعة كبيرة لم يتح لإيلا فيه وقت لتدرك حقيقة ما يجري، ولكي تحذر من الحبّ.
دهم الحبّ إيلا بغتة وبعنف كما لو أن أحداً ألقى حجراً من مكان ما في بركة حياتها الساكنة.
مقدمة:
كان القرن الثالث عشر، المفعم بالصراعات الدينية، والنزاعات السياسية، والصراعات اللانهائية على السلطة، فترة مضطربة في منطقة الأناضول. ففي الغرب، احتل الصليبيون القسطنطينية وعاثوا فيها فساداً وهم في طريقهم لاحتلال القدس، فقسمت الامبراطورية البيزنطية. وفي الشرق، انتشرت جيوش المغول بسرعة كبيرة بقيادة القائد العسكري العبقري جنكيزخان. وفي الوسط، كانت القبائل التركية المختلفة تتحارب فيما بينها، بينما كان البيزنطيون يحاولون استرجاع أرضهم وثروتهم وقوتهم التي فقدوها. كانت فترة من الفوضى لم يسبق لها مثيل، حيث كان المسيحيون يقاتلون المسيحيين، والمسيحيون يقاتلون المسلمين، والمسلمون يقاتلون المسلمين. فحيثما ولىّ المرء وجهه، كان هناك اقتتال وألم وخوف شديد لما يمكن أن يحدث بعد ذلك. وفي خضم هذه الفوضى، عاش عالم إسلامي جليل، يعرف باسم جلال الدين الرومي، ويُلقّب "بمولانا"، يحيط به آلاف المريدين والمعجبين من المنطقة كلها وما وراءها، وكان يُعتبر منارة للمسلمين جميعاً.
وفي سنة 1244ميلادي، التقى الرومي بشمس – الدرويش الجوّال ذو التصرفات الغريبة والآراء الهرطقية. وقد غيّر لقاؤهما هذا حياة كلّ منهما. وكان هذا اللقاء بداية لصداقة فريدة متينة شبّهها الصوفيون في القرون التالية باتحاد محيطين اثنين. وبعد لقاء الرومي بهذا الرفيق الاستثنائي، تحوّل من رجل دين عادي إلى شاعر يجيش بالعاطفة، وصوفي ملتزم، وداعية إلى الحبّ، فابتدع رقصة الدراويش، وتحرر من جميع القيود والقواعد التقليدية. وفي عصر سادته روح التعصب والنزاعات الدينية، دعا إلى روحانية عالمية شاملة، مشرعاً أبوابه أمام جميع البشر من مختلف المشارب والخلفيات. وبدلاً من أن يدعو إلى الجهاد الخارجي، الذي يعرّف "بالحرب على الكفّار"، الذي دعا إليه الكثيرون في ذلك الزمان، تماماً كما يجري في يومنا هذا – دعا الرومي إلى الجهاد الداخلي، وتمثّل هدفه في جهاد "الأنا"، وجهاد "النفس" وقهرها في نهاية الأمر.
لكن أفكاره لم تلق ترحيباً من جميع الناس، ولم يفتحوا جميعهم قلوبهم للمحبّة. وأصبحت الرابطة الروحية القوية بين شمس التبريزي والرومي نهباً للشائعات والافتراءات والتهجمات. وأسيء فهمهما، وأصبحا موضع حسد، وذمّ، وحطّ الناس من قدرهما، وخانهما أقرب المقربين إليهما. وبعد مضي ثلاث سنوات على لقائهما، انفصلا على نحو مأساوي.
لكن القصّة لم تنته هناك.
في واقع الحال، لم تكن هناك نهاية. فبعد مضي زهاء ثمانمائة سنة، لا تزال روح شمس وروح الرومي تنبضان بالحياة حتى يومنا هذا، تدوران في وسطنا في مكان ما...
القاتل
الإسكندرية، تشرين الثاني (نوفمبر) 1252
تحت مياه داكنة في أحد الآبار، يرقد ميتاً الآن. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت عيناه تتبعاني حيثما ولّيت، براقتان، مهيبتان، مثل نجمتين داكنتين، معلقتين على نحو ينذر بالشؤم في أعالي السماء. فقد أتيت إلى الإسكندرية بأمل أن أستطيع، إن أنا سافرت إلى مكان بعيد، أن أهرب من هذه الذاكرة الثاقبة وأن أوقف ذلك العويل الذي يتردّد صداه في رأسي، تلك الصيحة الأخيرة التي انطلقت منه قبل أن يصفى دمه، وتجحظ عيناه، وتغلق حنجرته في لهاث غير منته، وداع رجل مطعون بالسكين. عواء ذئب وقع في مصيدة.
عندما تقتل أحداً، فإن شيئاً منه ينتقل إليك - تنهيدة، أو رائحة، أو إيماءة. وأنا أدعوها "لعنة الضحيّة". تلتصق بجسمك وتتغلغل في جلدك، وتسري مباشرة إلى قلبك، وتظل تنغل في داخلك. ولا يملك أحد ممن يراني في الشارع وسيلة معرفة ذلك، لكني أحمل معي آثار جميع الرجال الذين قتلتهم. أعلقهم حول رقبتي مثل قلائد خفية، أحسّ بوجودهم فوق لحمي، بإحكام وبثقل. ومع أنني لا أشعر بالراحة، فقد اعتدت العيش مع هذا العبء، وقبلته كجزء من عملي. ومنذ أن قتل قابيل هابيل، ففي كلّ قاتل، يتنفّس الرجل الذي قتله، هذا ما أعرفه، وهو أمر لا يزعجني. لم يعد يزعجني. لكن، لماذا اعترتني تلك الرجفة القوية بعد تلك الحادثة السريعة؟
كان كلّ شيء مختلفاً هذه المرة، منذ البداية. فهاكم الطريقة التي وجدت العمل فيها مثلاً، أم هل عليّ أن أقول الطريقة التي وجدني فيها العمل؟ ففي بداية ربيع سنة 1248، كنت أعمل لدى صاحبة مبغى في قونية، خنثى معروفة بشدّة غضبها، وكنت أساعدها في مراقبة العاهرات، وبث الرعب في نفوس الزبائن الذين لا يحسنون التصرف.
أذكر ذلك اليوم بجلاء. فقد كنت أطارد عاهرة هربت من المبغى بحثاً عن الله. كانت شابّة جميلة، كادت تحطم قلبي، لأنني إذا ما لحقت بها، كنت أنوي أن أشوّه وجهها بحيث لا يعود رجل يرغب في النظر إليه. كنت على وشك الإمساك بهذه المرأة الغبية عندما وجدت رسالة غامضة ملقاة عند عتبة باب بيتي. ولمّا كنت أمياً لا أجيد القراءة، فقد أخذتها إلى المدرسة، وأعطيتها لأحد الطلاب ليقرأها لي ودفعت له مبلغاً لقاء ذلك.
ثم تبين لي أنها رسالة من مجهول وقّع عليها "عدد من المؤمنين المخلصين".
تقول الرسالة: "لقد عرفنا من مصدر موثوق من أنت ومن أين أتيت وأين تعمل. عضو سابق في فرقة الحشاشين! ونعرف كذلك أن الفرقة لم تعد قوية كما كانت بعد أن مات حسن الصباح وسجن زعمائك. ونعرف أنك جئت إلى قونية هرباً من القصاص، وأنك تعيش متنكّراً منذ ذلك الحين".
وذكرت الرسالة أنهم في حاجة ماسة إلى خدماتي، وأنهم سيدفعون لي مبلغاً جيداً من المال. وقالوا إن عليّ، إن كنت مهتمّاً بالأمر، أن أتوجه إلى حانة مشهورة في ذلك المساء بعد حلول الظلام. وعندما أصل إلى تلك الحانة، أجلس إلى أقرب طاولة إلى النافذة، مولياً ظهري للباب، مطرق الرأس، وأن أثبّت عينيّ في الأرض. ثمّ سيأتي إليّ الشخص أو الأشخاص الذين سيستخدمونني، ويقدمون لي كلّ المعلومات التي أحتاج إلى معرفتها. ويجب عليّ ألاّ أرفع رأسي وأنظر إلى وجوههم عندما يصلون أو عندما يغادرون، أو خلال حديثنا.
كانت رسالة غريبة. لكني كنت معتاداً على التعامل مع نزوات الزبائن. فعلى مرّ السنين، استخدمني أشخاص من جميع الأنواع، وكان معظمهم يرغب في الاحتفاظ بسرية أسمائهم. وعلّمتني التجربة، أنه في أحيان كثيرة، كلما بذل الزبون جهداً لإخفاء هويته، كان أقرب إلى ضحيّته، لكن لا شأن لي بذلك. إذ تنحصر مهمّتي في تنفيذ عملية قتل. وألاّ أسأل عن الأسباب الكامنة وراء مهمتي. ومنذ أن غادرت "ألموت" منذ عدة سنوات، كانت تلك هي الحياة التي اخترتها لنفسي.
وفي جميع الأحوال، نادراً ما كنت أطرح أسئلة. فلماذا أسأل؟ فمعظم الذين أعرفهم لدى كل واحد منهم على الأقل شخص يريد التخلّص منه. وعندما لا يفعلون شيئاً إزاء ذلك، فهذا لا يعني أنهم محصّنون من الرغبة في قتلهم. وفي الواقع، توجد في داخل كلّ شخص رغبة دفينة في قتل أحدهم ذات يوم. والناس لا يدركون ذلك، إلا بعد أن تحدث لهم. فهم يظنون أنهم عاجزون عن القتل. لكن المسألة مسألة ضمير فحسب. ففي بعض الأحيان، تكفي مجرد إيماءة لتأجيج سورة غضبهم. سوء فهم متعمّد، شجار على شيء تافه، أو أن يتواجد المرء في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ، إذ يمكن أن تظهر نزعة تدميرية لدى الأشخاص الذين يكونون أشخاصاً طيبين ومحترمين في الأحوال العادية. إذ يمكن لأي شخص أن يقتل أي شخص. لكن ليس بإمكان أي شخص أن يقتل شخصاً غريباً عامداً متعمداً، وهنا أدخل إلى الصورة.
كنت أنفذ الأعمال القذرة لصالح الآخرين. حتى الله أدرك الحاجة إلى شخص مثلي في خطته المقدّسة عندما عيّن عزرائيل، ملاك الموت، لإنهاء حياة الناس. وهكذا يخاف الناس الملاك ويلعنونه ويمقتونه، بينما تظل يدا الله نظيفتين، ويظل اسمه نقياً. وفي ذلك جور على هذا الملاك. لكن للمرة الثانية أقول إن العالم كله يسوده الظلم، أليس كذلك؟
عندما هبط الليل، توجهت إلى الحانة. وشاءت الصدف أن يجلس رجل في وجهه ندبة، إلى الطاولة بالقرب من النافذة، ويغطّ في النوم. خطر لي أن أوقظه وأطلب منه الانتقال إلى طاولة أخرى، لكنك لا تعرف ماذا يمكن أن تكون عليه ردة فعل السكارى، لذلك كان عليّ أن أتوخى الحذر، وألاّ ألفت الانتباه إليّ. لذلك، جلست إلى الطاولة الفارغة التالية، قبالة النافذة.
وبعد قليل وصل رجلان، وجلسا إلى جانبيّ لكي لا أرى وجهيهما. لم أكن بحاجة لأن أنظر إليهما، لأدرك أنهما شابان، وأنهما غير مستعدين لاتخاذ الخطوة التي كانا على وشك اتخاذها.
"لقد جاءتنا توصية عالية بك"، قال أحدهم، لم تكن نبرته حذرة بقدر ما كانت متردّدة، "قيل لنا إنك الأفضل".
بدت طريقة قوله مضحكة، لكنني كتمت ابتسامتي. لاحظت أنهما كانا خائفين، وهو أمر جيد. فعندما يكونان خائفين، لن يجرآ على ارتكاب أي خطأ معي.
لذلك قلت: "نعم، أنا الأفضل، لذلك يطلقون عليّ اسم "رأس ابن آوى". ولم أخذل زبائني قط، مهما بلغت صعوبة تلك المهمّة".
"جيد"، قال متنهّداً، "لأن هذه المهمة قد لا تكون سهلة".
وهنا تحدّث الشاب الآخر وقال: "انظر، لقد كسب هذا الرجل لنفسه أعداء كثيرين. فمنذ أن جاء إلى هذه البلدة، لم يجلب شيئاً سوى المشاكل. حذّرناه عدة مرات، لكنه لم يستمع إلى قولنا له، وأصبح مشاكساً ومثيراً للمشاكل.لم يدع أمامنا أي خيار آخر".
كانت الأمور تسير على هذا المنوال باستمرار. ففي كلّ مرة، يحاول الزبائن تفسير ما سيقدمون عليه، قبل أن نتوصل إلى اتفاق، وكأن موافقتي قد تقلّل من خطورة ما سيقدمون على عمله.
فسألتهما، "فهمت قصدكما. قولا لي، من هو هذا الشخص؟" ترددا في ذكر الاسم، وقدما أوصافاً غامضة.
"إنه رجل زنديق لا يمت بصلة إلى الإسلام. إنه عنيد، جامح، يكتنفه الرجس والكفر. إنه درويش مارق".
ما إن سمعت الكلمة الأخيرة، حتى سرى في ذراعي إحساس مخيف. وأخذ عقلي يفكّر بسرعة. لقد قتلت جميع أنواع البشر، صغاراً وكباراً، رجالاً ونساء، لكنني لم أقتل قط درويشاً، رجلاً مؤمناً. فأنا أؤمن بالخرافات ولم أكن أرغب في أن أجلب عليّ غضب الله، لأنني على الرغم من كلّ شيء، أؤمن به.
"أظن أني سأرفض طلبكما. لا أظن أني أريد أن أقتل رجل دين. ابحثا عن شخص آخر".
وبنهاية قولي هذا، استويت واقفاً متهيئاً للمغادرة. لكن أحد الرجلين أمسكني من يدي، وقال متوسلاً: "انتظر أرجوك: سيتناسب المبلغ مع الجهد الذي ستبذله. ومهما بلغ الأجر الذي تتقاضاه، فإننا على استعداد لمضاعفة المبلغ".
"ماذا عن ثلاثة أضعاف؟" سألتهما، مقتنعاً بأنهما لن يزيدا المبلغ كثيراً.
لكن لدهشتي، وبعد تردد، وقف كلاهما. عدت وجلست في مقعدي، متوتراً. فبهذا المبلغ يمكنني أن أسدد مهر عروس وأن أتزوّج أخيراً، ولن يساورني قلق بشأن تدبير أمور معيشتي. درويشاً أم غير دوريش، فأي شخص جدير بأن يقتل لقاء هذا المبلغ.
كيف كان لي أن أعرف أنني ارتكبت في تلك اللحظة أكبر خطأ في حياتي، وأنني سأمضي بقية حياتي نادماً على ما اقترفته يداي؟ كيف يمكنني معرفة أن قتل الدرويش سيكون أمراً في غاية الصعوبة، وأنه حتى بعد مرور فترة طويلة على وفاته، ستتعقبني نظرته الحادة كالسكين في كل مكان؟
مضت الآن أربع سنوات منذ أن طعنته في ذلك الفناء، وألقيت بجسده في بئر، ورحت أنتظر سماع صوت سقوطه في الماء، وهو ما لم أسمعه أبداً. لم يصدر أي صوت. فبدل أن يسقط في الماء، يبدو أنه صعد إلى السماء. وما زلت لا يغمض لي جفن من دون أن تنتابني كوابيس، وعندما أنظر إلى الماء، أيّ مصدر ماء، لبضع ثوان، يتملك جسدي كله رعب بارد، فأتقيأ.
شمس
حانة في ظاهر سمرقند، آذار (مارس) 1242
ارتعش أمام عينيّ ضوء الشموع المصنوعة من شمع النحل والمنتصبة فوق المنضدة الخشبية المتشققة. وغمرتني هذا المساء رؤية شديدة الإشراق.
رأيت بيتاً كبيراً ذا فناء تكسوه الورود المتبرعمة الصفر، وفي وسط الفناء بئر بقبع فيه أبرد ماء في الدنيا. كانت ليلة صافية في أواخر الخريف، وقد تكبد البدر صفحة السماء الصافية. تناهت إليّ من بعيد أصوات نعيق وعواء حيوانات ليلية. وبعد قليل، خرج من البيت رجل في منتصف العمر، لطيف الوجه، له كتفان عريضتان، وعينان عميقتان بندقيتا اللون، يبحث عني. كانت قسمات وجهه متوترة، وعيناه تشيان بحزن شديد.
"شمس، شمس، أين أنت؟" صاح وهو يتلفت يميناً ويساراً.
هبّت ريح عاصفة، وتوارى القمر وراء غيمة،كأنه لا يريد أن يشهد ما سيحدث. وتوقّف البوم عن النعيب، ولم يعد الخفاش يصفق بجناحيه، وحتى النار في الموقد داخل البيت، لم تعد تصطفق.
وأطبق سكون تام على العالم.
ببطء، اقترب الرجل من البئر، وانحنى، وراح ينظر إلى الأسفل. وهمس، "شمس، يا أعزّ أعزائي، هل أنتَ هنا؟"
فتحت فمي لأجيب، لكن لم ينبعث من بين شفتيّ أي صوت.
انحنى الرجل أكثر، وحدّق في البئر ثانية. في البداية لم ير شيئاً سوى سواد الماء. لكنه بعد ذلك، وفي أعماق البئر، رأى يدي تطوف بلا هدف فوق الماء المترقرق، مثل طوافة زعزعتها الريح الشديدة. ثم تبيّن عينين – حدقتان سوداوان تلمعان، تحدقان في البدر الذي بدأ ينسلّ الآن من وراء الغيوم الداكنة الكثيفة. تسمّرت عيناي على القمر كأنهما تنتظران تفسيراً من السماء عن سبب قتلي.
خرّ الرجل ساجداً، وراح يجهش في البكاء ويخبط على صدره بقبضتيه ويصرخ: "لقد قتلوه! لقد قتلوا شمساً".
عندئذ انبثق ظلّ من وراء أجمة، وبحركات سريعة خفية قفز فوق جدار الحديقة، مثل قطّ بري. لكن الرجل لم ير القاتل. كان يُعتصر ألماً، ولم يكفّ عن الصراخ والعويل حتى تهشم صوته كما يتهشم الزجاج، وتناثر في أرجاء الليل في شظايا دقيقة واخزة.
"هيه، أنت! كفّ عن الصراخ كالمجنون".
"...."
"كفّ عن هذا الصراخ وإلا طردتك خارجاً".
"..."
"قلت اخرس! هل تسمعني؟ اسكت".
كان صوت الرجل الذي صدرت منه هذه الكلمات، يزداد قرباً مني على نحو مخيف. تظاهرت أنني لم أسمعه، مفضّلاً البقاء داخل رؤياي لأطول فترة من الزمن. كنت أريد أن أعرف المزيد عن موتي، كما كنت أريد أن أرى الرجل صاحب أشدّ العيون حزناً. من هو؟ ما علاقته بي، ولماذا كان يبحث عنّي باستماتة في ليلة من ليالي الخريف؟
لكن قبل أن أتمكن من اختلاس نظرة أخرى، أمسكني أحدهم من ذراعي من عالم آخر وراح يهزني بقوة حتى أحسست بأسناني تصطك في فمي. وجرتني قبضته إلى هذا العالم.
ببطء، وبتردّد، فتحت عينيّ ورأيت الرجل يقف بجانبي. كان رجلاً مربوع القامة، له لحية وَخَطَها الشيب، وله شاربان كثان، معقوفان ومفتولان عند الطرفين. أدركت أنه صاحب الحانة. وعلى الفور لاحظت أمرين اثنين فيه وهما: أنه الرجل الذي يزرع الخوف في نفوس الناس بكلامه الفظ وسلوكه العنيف؛ وأنه الآن في حالة غضب شديد.
سألته، "ماذا تريد؟ لماذا تشدّ ذراعي؟"
"ماذا أريد؟" قال صاحب الحانة هادراً، متجهماً، "أريد أن تكفّ عن الصراخ، هذا ما أريد. إنك تبث الخوف في زبائني".
"حقاً؟ هل كنت أصرخ؟" دمدمت بعد أن حررت يدي من قبضته.
"أراهن على أنك كنت تصرخ! كنت تصرخ مثل دب انغرزت في كفّه شوكة. ماذا دهاك؟ هل غفوت أثناء العشاء؟ لا بدّ أنك رأيت كابوساً أو شيئاً من هذا القبيل".
أعرف أن هذا هو التفسير المعقول الوحيد، وأنني لو قبلته، لقبل صاحب الحانة وتركني أغادر بسلام. لكني لم أرد أن أكذب".
فقلت: "لا، يا أخي، فأنا لم أنم ولم أر كابوساً. بل إنني لا أرى أحلاماً قط".
" إذن كيف تفسر صراخك هذا؟" أراد صاحب الحانة أن يعرف.
فقلت: "لقد جاءتني رؤيا. وهذا أمر مختلف".
رمقني بنظرة ملؤها الحيرة ولعق طرفي شاربيه، ثم قال: "أنتم الدراويش مجانين كالجرذان في مخزن المؤن، ولاسيما الدروايش الجوالون. فأنتم تصومون النهار كلّه، وتصلّون وتمشون تحت أشعة الشمس الحارقة. لا عجب أنك بدأت تهلوس – ثمة لوثة في عقلك".
ابتسمتُ. قد يكون محقّاً في القول إن هناك خيطاً رفيعاً بين أن تستغرق في الله وأن تفقد عقلك.
في تلك اللحظة، ظهر صبيّان خادمان، يحملان بينهما صينية ضخمة كدّست فوقها أطباق كثيرة: عنزة مشوية، سمك مجفّف مملّح، لحم ضأن متبّل، وكعك مصنوع من الحنطة، وحمص مع قطع من كرات اللحم، وشوربة عدس طهيت بإلية خروف. وأخذا يطوفان في أرجاء القاعة، يوزعان الطعام على الحاضرين، مالئين الهواء بروائح البصل والثوم والتوابل. وعندما توقّفا عند طرفيّ المائدة، أخذت زبدية من الحساء كان البخار يتصاعد منها وقليلاً من الخبز الأسمر الغامق.
"هل لديك نقود تدفع ثمنها؟" سأل صاحب الحانة، بشيء من العجرفة.
فقلت: "لا، لا نقود لديّ، لكن يمكنني أن أقدم لك شيئاً مقابل ذلك. مقابل الطعام والإقامة. إذ يمكنني أن أفسّر لك أحلامك".
فرد باحتقار، واضعاً ذراعيه على خصره، "لقد قلت للتو إنك لا ترى أحلاماً".
"صحيح. فأنا مفسّر أحلام ولكن لا أرى أحلاماً".
"يجب أن ألقي بك إلى الخارج. كما قلت، إنكم معشر الدراويش مجانين"، قال صاحب الحانة.
"ها هي نصيحة أقدمها لك. فأنا لا أعرف كم عمرك، لكنني واثق من أنك صلّيت بما يكفي لكلا العالمين. جد امرأة جميلة واستقرّ. انجب أطفالاً. فهذا سيساعدك على أن تبقي قدميك على الأرض. فما فائدة التجوال في العالم والبؤس والتعاسة منتشران في كل مكان؟ صدقني. لا شيء جديد. عندي زبائن من أقصى أصقاع العالم، وبعد أن يجرعوا بعض الكؤوس، أسمع القصص نفسها منهم جميعاً. فالبشر هم أنفسهم في كل مكان. والطعام نفسه، والماء نفسه، والحماقة القديمة نفسها".
فقلت: "إني لا أبحث عن شيء مختلف. إني أبحث عن الله. إن مسعاي هو البحث عن الله".
فردّ وقد غلظ صوته فجأة، "إذن فإنك تبحث عنه في المكان الخطأ. لقد هجر الله هذا المكان! ولا نعرف متى سيعود".
عندما سمعت هذه الكلمات، سقط قلبي فوق جدار صدري، وقلت: "عندما لا يذكر المرء الله بسوء، فإنه يسيء التكلّم عن نفسه".
ارتسمت على فم صاحب الحانة ابتسامة خبيثة؛ ورأيت في وجهه مرارة واستياء، وشيئاً آخر يشبه الألم المرتسم على وجه طفل.
ثم سألته: "ألا يقول الله "وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ"؟ فالله لا يقبع بعيداً في السموات العالية، بل يقبع في داخل كلّ منا. لذلك فهو لا يتخلّى عنا، فكيف له أن يتخلّى عن نفسه؟"
"لكنه لا يتخلى عنا"، ردد صاحب الحانة، عيناه باردتان ومتحدّيتان، "إن كان الله هنا فهو لا يحرك ساكناً، ونحن نعاني من أسوأ النهايات، فماذا يعني ذلك؟"
فقلت: "إنها القاعدة الأولى يا أخي: إن الطريقة التي نرى فيها الله ما هي إلا انعكاس للطريقة التي نرى فيها أنفسنا. فإذا لم يكن الله يجلب إلى عقولنا سوى الخوف والملامة، فهذا يعني أن قدراً كبيراً من الخوف والملامة يتدفّق في نفوسنا. أما إذا رأينا الله مفعماً بالمحبة والرحمة، فإننا نكون كذلك".
فأجاب صاحب الحانة معترضاً، لأن كلماتي فاجأته، "كيف يختلف ذلك عن القول بأن الله هو صورة من نسج خيالنا؟ لم أفهم".
لكن جلبة صاخبة انبعثت من خلف قاعة الطعام، جعلتني أتوقف عن إجابته. وعندما التفتنا نحو مصدر الصوت، رأينا رجلين فظين ثملين يهذران بصوت عال بكلام غير مفهوم. وقد أطلقا العنان للإهانات والشتائم، وأدخلا الرعب في نفوس الزبائن الآخرين، وراحا يختطفان الطعام من طاساتهم، ويشربان من أكوابهم، فإذا أبدى أحد احتجاجاً، كانا يسخران منه مثل صبيين شقيين في "كُتَّاب".
"ألا تظن أنه يجب أن يكبح أحد جماح هذين الغوغائيين؟" همس صاحب الحانة بين أسنانه المطبقة، وأضاف، "انظر ماذا سأفعل الآن".
وبلمح البصر بلغ نهاية القاعة، فشدّ أحد الزبونين الثملين من مقعده، ولطمه على وجهه. لا بد أن الرجل لم يكن يتوقّع ذلك قط، فتهاوى على الأرض مثل كيس فارغ. وسوى آهة خفيفة انبعثت من بين شفتيه، لم يندَّ عنه أي صوت.
وتبين أن الرجل الآخر أقوى من الأول، فقد قاوم بعنف، لكن صاحب الحانة سرعان ما ألقى به أرضاً، وبدأ يركل زبونه الحرون على أضلاعه، ثم داس على يده، وسحقها تحت حذائه الثقيل. وسمعنا صوت طقطقة إصبع، أو أكثر ينكسر.
فصحت، "توقّف عن ذلك. إنك ستقتله. أهذا ما تنوي عمله؟"
ولمّا كنت صوفياً، فقد أقسمت على أن أحمي حياة الناس وألاّ ألحق أذى بأحد. ففي عالم الأوهام الذي نحياه، يوجد الكثير من الناس المستعدين للتشاجر دونما سبب، وآخرون يتشاجرون لسبب ما. أما الصوفي فلا يتشاجر مع أحد حتى لو كان لديه سبب يدعوه إلى ذلك. فلا يوجد ثمة داع يجعلني ألجأ إلى العنف. لكن بإمكاني أن ألقي بنفسي مثل بطانية ناعمة بين صاحب الحانة والزبونين لأفصلهم عن بعضهم.
"ابتعد أيها الدرويش، وإلا ضربتك أنت أيضاً ضرباً مبرحاً"، صاح صاحب الحانة، مع أننا كنا نعرف أنه لن يفعل ذلك.
بعد دقيقة حمل الخادمان الزبونين اللذين كُسر إصبع أحدهما، وكُسر أنف الآخر، وتناثر الدم في كل مكان. وخيّم على قاعة الطعام صمت مفعم بالخوف. ثم رمقني صاحب الحانة، الذي كان فخوراً بالرعب الذي أشاعه، بنظرة جانبية. وعندما تكلم ثانية، بدا وكأنه يخاطب الحاضرين جميعاً، وارتفع صوته وأصبح مسعوراً، مثل طير من الجوارح يحوم بخيلاء في السماء.
"كما ترى أيها الدرويش، فالأمور لا تسير هكذا على الدوام. فلم يكن العنف من شيمي، لكنه أصبح الآن. فعندما ينسانا الله ويتركنا وحيدين هنا، يقع على عاتقنا، نحن الناس العاديين، أن نصبح أشداء أو نحقق العدل بأيدينا. لذلك عندما تكلمه في المرة القادمة، أرجو أن تخبره ذلك. وسأقول له إنه عندما يتخلى عن حملانه، فلن تنتظر هذه الحملان بوداعة وخنوع حتى تُذبح. بل ستتحول إلى ذئاب".
هززت كتفي ّوأشرت نحو الباب، وقلت: "إنك مخطئ".
"هل أخطأت في القول بأنني كنت حملاً ذات يوم وأصبحت ذئباً اليوم؟"
"لا، إنك محق. فأنا أرى أنك أصبحت ذئباً حقاً، لكنك أخطأت عندما قلت إنك تحقق العدالة".
"انتظر،لم أفرغ منك بعد"، صاح صاحب الحانة ورائي، "إنك مدين لي. مقابل الطعام والمأوى، كنت ستفسّر لي أحلامي".
"سأفعل شيئاً أفضل"، اقترحت، "سأقرأ لك كفّك".
استدرت وسرت نحوه، وأنا أحدّق في عينيه الملتهبتين. وبشكل غريزي، ومرتاب، أجفل. لكنني عندما أمسكت يده اليمنى، ورفعت راحتيَ يديه إلى الأعلى،لم يدفعني جانباً. وأمعنت النظر في خطوط راحته، فوجدتها عميقة، مشققة، تشير إلى دروب وممرات متقطعة غير مستقيمة. وشيئاً فشيئاً، بدت لي الألوان في هالته: بني بلون الصدأ، وأزرق شاحب أقرب إلى الرمادي. وأصبحت طاقته الروحية جوفاء مقعّرة، ورقّت حول الحافات، كما لو خلت منه أي قوة للدفاع عن نفسه من العالم الخارجي. وفي أعماقه، لم يعد في الرجل حياة أكثر مما في نبتة ذابلة. وللتعويض عن فقدان طاقته الروحية، ضاعف من طاقته الجسدية، التي أفرط في استخدامها.
بدأ قلبي يخفق بسرعة، لأنني بدأت أرى شيئاً. في البداية على نحو باهت، كما لو كان من وراء حجاب، ثمّ بدأ يتضح أكثر، ثمّ برز أمام عينيّ مشهد.
شابّة ذات شعر كستنائي، وقدمين حافيتين رسم عليهما وشم أسود، وحول كتفيها التف شال أحمر مطّرز.
قلت: "لقد فقدت حبيبة"، وأمسكت راحة يده اليسرى بيدي.
كان ثدياها يطفحان بالحليب، وبطنها ضخمة جداً وكأنها ستتمزّق إرباً إرباً. كانت عالقة في كوخ يحترق. وكان محاربون يدورون حول البيت، ممتطين خيولاً عليها سروج من الفضة والذهب. وكانت تفوح رائحة واخزة من احتراق القشّ واللحم البشري.
فرسان مغول، أنوفهم مفلطحة وعريضة، رقابهم غليظة وقصيرة، وقلوبهم قاسية كالصوان. جيش جنكيزخان القوي.
"لقد فقدتَ حبيبين"، قلت مصحّحاً نفسي، "فقد كانت زوجتك حاملاً بطفلك الأول".
قوّس صاحب الحانة حاجبيه، وثبّت عينيه على حذائه الجلدي الطويل، وزمّ شفتيه بشدة، وتغضّن وجهه مثل خريطة لا يمكن تبين معالمها. وفجأة بدت عليه ملامح الشيخوخة أكثر من عمره الحقيقي.
قلت: "أعرف أن هذا ليس تعزية لك، بل أظن أن هناك شيئاً يجب أن تعرفه. فلم تقتلها النار أو الدخان. بل انهار لوح خشبي من السقف وسقط على رأسها، وماتت على الفور، من دون ألم. كنت تظن دائماً أنها عانت كثيراً، لكنها في الحقيقة، لم تتألم على الإطلاق".
قطّب صاحب الحانة حاجبيه، وانحنى بتأثير ضغط لا يفهمه أحد سواه؛ وازداد صوته خشونة عندما سأل، "كيف عرفت كل ذلك؟"
تجاهلت سؤاله، وقلت: "إنك تلوم نفسك لأنك لم تقم لها جنازة لائقة. إنك لا تزال تظهر في أحلامك، تخرج زاحفة من الحفرة التي دفنت فيها، لكن عقلك يتلاعب بك. في الحقيقة، إن زوجتك وابنك بخير، وهما يتنقلان في العالم اللا نهائي، حرّان مثل نقطتي نور".
ثمّ أضفت، وأنا أدرس كلّ كلمة أقولها بعناية، "يمكنك أن تصبح حملاً ثانية، لأنك لا تزال تحتفظ بالحمل في داخلك".
عندما سمع ذلك، سحب صاحب الحانة يده من يدي، كما لو أنه لمس مقلاة ساخنة، وقال: "لا أحبّك، أيها الدرويش. سأسمح لك بالمكوث هنا الليلة، لكنك يجب أن تغادر في الصباح الباكر. لا أريد أن أرى وجهك هنا ثانية".
هكذا هي الحياة. فعندما تخبر أحدهم بالحقيقة، فإنه يكرهك. وكلما تحدّثت عن الحبّ، ازدادت كراهيته لك.
التعليق
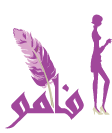

 من نحن
من نحن أشواك الورد
أشواك الورد قصاصات.كوم
قصاصات.كوم متابعات
متابعات فضاء للبوح
فضاء للبوح سرديات
سرديات قصائد
قصائد آراء حرة
آراء حرة في المرآة
في المرآة الأسوأ
الأسوأ دليل فامو
دليل فامو Boutique FaMoh
Boutique FaMoh Café FaMoh
Café FaMoh إتصل بنا
إتصل بنا